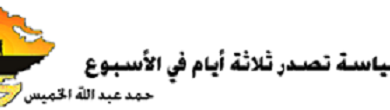معركة وادي المخازن.. حين أباد المسلمون في المغارب جيوش البرتغال

شهدت بدايات القرن السادس عشر الميلادي تحولا كبيرا مع الأتراك العثمانيين باعتبارهم أقوى الدول الإسلامية حينذاك، لا سيما في عهدَيْ سليم الأول وسليمان القانوني، إذ حمل السلطان العثماني لقب خادم الحرمين الشريفين، وربما حمل لقب الخلافة، الأمر الذي أدرك معه المغاربة أن التطلع لهذه الدولة أو السلطنة الكبرى أمر لا مفر منه لدفع عادية الإسبان والبرتغاليين ومظاهر الاستعمار لبلاد المغرب العربي.
وكان الوجود العثماني في بلاد المغرب بداية بالدور العسكري الذي قام به إخوان بربروسا الذين استقروا في ميناء جيجلي الجزائري وتسيّدوه، وكانوا أربعة إخوة، هم عروج وإلياس وإسحاق وخير الدين، ويصل نسبهما إلى أب تركي وأم أندلسية عاشا حياة الجهاد العثماني انطلاقا من جزيرة ميدلّي في بحر إيجة التابعة لليونان اليوم، قد انطلق هؤلاء اليوم في خدمة الجهاد البحري الإسلامي تجاه المد البرتغالي والإسباني وأساطيل البندقية وجنوة وغيرهم من الأوروبيين، كما اتخذ عروج من مدينة أو جزيرة جربة التونسية أولى قواعده في بلاد المغرب الكبير.
ثم سرعان ما توغل الأتراك العثمانيون بطلب من الحفصيين حكام المغرب الأدنى والزيانيين حكام المغرب الأوسط، فأقطعهم السلطان الحفصي مناطق حلق الوادي، واستطاع عروج أن يُحرِّر مدينة جيجل التي احتلّها الجنويون الطليان سنة 1514م، وفي عام 1516م أرسل السلطان العثماني سليم الأول ميرا سنويا، وعتادا، وسِكة (عملة) عثمانية إلى عروج وإخوته في أول مظاهر السيادة العثمانية على تلك المناطق. ورأت المدن التونسية والجزائرية ووجوه الناس وأشرافها منذ ذلك التاريخ في الوجود التركي حصنا لهم، بعد أن كانوا قد اضطروا إلى دفع الجزية للإسبان بعد نكبة وهران سنة 1509م التي انتصر فيها الإسبان على بني زيّان حكام تلك المناطق، وأعلن السلطان الزياني أبو حمّو الثالث تبعيته وخضوعه المباشر للسيادة الإسبانية.
وفي المغرب الأقصى، تعرّضت سواحله لغارة شرسة من البرتغاليين والإسبان أيضا منذ مطلع القرن الخامس عشر الميلادي، وقد بدأت تلك الغارات حين وقع نزاع بينهما حول ملكية جزر الكناريا التي اعتبرها كلٌّ من الطرفين نقطة انطلاق وتوسُّع في غرب أفريقيا، ولأهمية هذه الجزر لم يشأ كلٌّ منهما التنازل عنها للآخر، وقد تدخلت الباباوية لحل هذا النزاع، وفي أثناء ذلك كانت السفن الإسبانية والبرتغالية تتوقف للتزود بالمؤن أو للتبادل مع مناطق شمال المغرب وسواحله، فعرفوا كثيرا من أخبار البلاد، ووقفوا على ضعف الدولة المرينية في فاس وعجزها عن إدارة شؤون البلاد العامة، وما وقع إثر ذلك من طواعين ومجاعات استغلّها البرتغاليون في احتلال مدينة سبتة سنة 1415م.
وفي عام 1454م أعطى البابا نيقولا الخامس للبرتغاليين براءة تجعل “سبتة” والممتلكات الأخرى التي احتلوها في غرب أفريقيا من نصيب التاج البرتغالي، وحثّ البابا البرتغاليين والإسبان على عدم التواني عن حرب المسلمين، ولم تمضِ أعوام قليلة على هذه البراءة حتى احتل البرتغاليون مدينة “القصر الصغير” المغربية الواقعة على مضيق سبتة وطنجة في أكتوبر/تشرين الأول سنة 1458م، وكان على رأس الحملة الملك البرتغالي ألفونسو الخامس، ثم لم يتوانَ البرتغاليون عن الهجوم على مدن أخرى تكلّلت باحتلالهم مدينة “أصيلا” في أغسطس/آب 1471م، فقويت شوكتهم في شمال المغرب، وطمحوا في اتخاذ هذه المراكز الساحلية الشمالية للانطلاق إلى عمق البلاد واحتلالها.
وقد دخل الإسبان ضد البرتغاليين في منافسة حامية لاحتلال بعض المدن المغربية، بل والاستيلاء على ما احتلّه البرتغاليون، فاحتل الإسبانيون سنة 1506 مدينة “غصاصة” أو غساسة “في إقليم الناطور” شمال المغرب، بينما فرض البرتغاليون سيطرتهم على منطقة الصويرة ثم آسفى سنة 1508م، وفي العام نفسه احتل الإسبان “حجرة بادس”، وفي عام 1509م وقع اتفاق بين الفريقين المتنافسين على اقتسام مناطق النفوذ بينهما، وأصبحت معظم سواحل المغرب الشمالية والغربية ومدنه وموانئه وحصونه واقعة تحت الاحتلالين البرتغالي والإسباني، في لحظات كانت البلاد تتعرّض فيها لفتن ومصاعب داخلية لا تكاد تنتهي.
صعود السعديين
كانت أكبر الفتن التي تعرّضت لها أقاليم وبلدان المغرب الأقصى الداخلية منذ نهايات عصر المرينيين وخلفائهم الوطّاسيين حكام البلاد الجدد فيما بين عامَيْ (1472-1552م)، وتحت وطأة الاحتلال الأجنبي لسواحل البلاد الشمالية والغربية، أنه قد عجزت هذه السلطات عن صيانة الأمن والدفاع عن البلاد، الأمر الذي أدّى إلى انتشار الفوضى والفتن وتجزئة المغرب إلى وحدات شبه مستقلة بعضها أملتها ضرورة الجهاد ومقاتلة العدو المحتل للسواحل، مثلما حدث في مدن شفشاون والقصر الكبير وتطوان.
وبسبب هذه الفتن والتفتُّت الداخلي للمغرب الأقصى، وعدم قدرة الوطّاسيين على حسم الأمور وقيادة البلاد أو مواجهة العدو بنجاح، فقد ظهر حينذاك اتجاهان؛ الأول يُمثِّله أصحاب المصالح الضيقة والشخصية في المناطق القريبة من العدو البرتغالي الذين رأوا في الدخول في طاعته ومهادنته والتقرب منه مصلحة وضرورة، وقد أفاد المحتل من هؤلاء العملاء ببناء الحصون والقلاع وبسط نفوذه على المناطق القريبة في الشمال، واتجاه آخر من المؤمنين الشرفاء الذين آلمهم ما تصل إليه بلدانهم من الانحدار والتشتت والاحتلال وممالأة العدو واستباحته وظهوره، وقد تجلّت هذه الدعوة الجديدة في مناطق الجنوب المغربي في بلاد السوس بوجه خاص، وقد رأت هذه الدعوة أن الموافقين بالحماية البرتغالية في حكم الخارجين عن الإسلام، وبدأ رؤساء القبائل وكبار المشايخ الصوفية والعلماء في البحث عن الشخصية الأقدر على تحمل مسؤولية الدفاع عن الإسلام وصيانة التراب المغربي من حالة الانحطاط والتشرذم والاحتلال التي بلغتها آنذاك.
ولقد رأى وجوه القوم في مناطق السوس بجنوب المغرب أن الأقدر على حمل تلك الأمانة وقيادة هذه المهمة رجل من أشراف الناس، يعود نسبه إلى آل البيت من نسل محمد النفس الزكية، وهو الشيخ الشريف محمد بن عبد الرحمن الحسني الذي كان يسكن مع قومه في مناطق درعة ببلاد السوس، وقد اشتهر بسعة العلم و”التمسك بسيرة السلف الصالح من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، كما يصف الزياني في تاريخه “المغرب في دول المشرق والمغرب”. ومنذ عام 1510م/916هـ بزغت الدولة السعدية، التي أطلق عليها المغاربة هذا اللقب لأنهم سعدوا في عهدها وشعروا بالأمن والسكينة من بعد الاحتراب والفتن.
استطاع السعديون القضاء على الحكم الوطاسي ومقاومة النفوذ البرتغالي واستعادة بعض حصونهم وموانئهم الشمالية مثل “سانتا كلوز”، وقد فتح السعديون ذراعيهم للعثمانيين الأتراك جيرانهم في الجزائر وتلمسان للتعاون ضد المحتلين الإسبان والبرتغال، كما تمكَّنَ السعديون من استعادة مدن أصيلا والقصر الكبير من الاحتلال البرتغالي وتوحيد أجزاء واسعة من المغرب الأقصى، حتى إنهم استطاعوا الاستيلاء على مدينة تلمسان من الأتراك، وكانت البداية الأخطر للخلاف التركي المغربي، لكن سرعان ما استعاد العثمانيون تلسمان، بل توسعوا حتى تمكّنوا من السيطرة على فاس ذاتها في يناير/كانون الثاني 1554م، لكن عاد السعديون وتمكّنوا من استرداد مدينتهم ووقفوا حائط صد ضد توسع العثمانيين في المغرب الأقصى.
أدرك السعديون مطامع العثمانيين في التوسع على حسابهم، فعملوا على علاقات متوازنة مع الإسبان والبرتغال والإنجليز من جانب، ومع العثمانيين من جانب آخر، وكانت وفاة السلطان السعدي الثالث أبي محمد الغالب بالله عام 1574م وتولية ابنه المولى محمد المتوكل على الله بداية لدخول المغرب إلى مرحلة حاسمة من تاريخه، لا سيما أن المتوكل على الله اتخذ إستراتيجية التقرب من الدول المسيحية ومسالمتها لصد خطر العثمانيين بمَن فيهم الإنجليز الذين أرادوا توسيع دورهم التجاري مع المغرب كما فعل والده.
وكانت سلطنة الغالب بالله قد شهدت أول التشققات الداخلية في البيت السعدي حين لجأ إخوته الثلاثة عبد المؤمن وعبد الملك وأحمد إلى العثمانيين في الجزائر وتونس طالبين منهم المساعدة لخلع أخيهم من العرش السعدي لتعاونه مع الإسبان والبرتغاليين، وعدم دخوله مع التحالف الإسلامي التركي، ولكن السلطان الغالب تجاوز هذه المناورة من إخوته بإقامة علاقات دبلوماسية هادئة مع الدولة العثمانية بدفع مبالغ مالية كبيرة كل عام، الأمر الذي هدّأ من حِدّة هذه التشققات وقتيا، وجعلت السلطان الغالب في موقف الممسك بمقاليد الأمور.
صعود المتوكل وتسارع الأحداث
بيد أن وفاته وصعود ابنه المتوكل على الله سنة 981هـ/1574م الذي اتخذ إستراتيجية والده في التقارب مع القوى الأوروبية قد هيّج أعمامه عبد الملك وأحمد المنصور وعبد المؤمن لعودة الاتصال بالأتراك العثمانيين وحثّهم على إزاحة هذا السلطان الجديد، وكان أتراك الجزائر وولاتها العثمانيون عازمين على الانتقام من المتوكل لتحالفه العلني مع الأوروبيين ضدهم، وفي هذه المرة أمدّ الأتراك الأعمام الثلاثة ضد ابن أخيهم بكل ما يحتاجون إليه من رجال وسلاح لا سيما بعد انتصارهم على الإسبان وإضعافهم في تونس.
ولقد عادت مراكش وفاس إلى ما كانتا عليه أحوالهما أيام بني وطاس من الضعف والفتن جراء منافسات أمراء البيت السعدي، والتي كان من جرائها عودة النشاط السياسي إلى أصحاب الرباطات من الصوفية والأتراك العثمانيين والنصارى الإسبان والبرتغال وزيادة نفوذهم وتدخلهم في الشؤون الداخلية، وأعطى السلطان العثماني قراره وتفويضه وعونه العسكري لعبد الملك السعدي، الذي كان متزوجا من ابنة أحد الباشاوات العثمانيين، بغزو فاس ومراكش، كما أمر والي الجزائر التركي بمساعدته على خلع المتوكل من العرش السعدي.
وبالفعل انطلق عبد الملك وأحمد المنصور وعبد المؤمن السعدي مع والي الجزائر العثماني نحو المغرب، وكانت القبائل والجموع المؤيدة لهم مستعدة لذلك التدخل، فلما اقتربت هذه القوات من دخول فاس انضم رئيس جند الأندلسيين في جيش المتوكل إلى عبد الملك والعثمانيين، وكان “جند الأندلسيين” من أهم الفِرَق وأكثرها قوة واستعدادا وكثرة عددية وحرفية، غير أنهم كانوا يُكنّون الكراهية والحقد للسلطان الغالب وابنه المتوكل لتحالفهما وتعاونهما مع أعدائهم الأقدمين من الإسبان والبرتغاليين الذين طردوهم من ديارهم وقتلوا إخوانهم في الأندلس، حينها أدرك المتوكل أنه مهزوم لا محالة، واتخذ قراره بالفرار من المعركة أمام الجيش التركي وعمّيه عبد الملك وأحمد المنصور، فهرب إلى مراكش واستولى عبد الملك على مدينة فاس في ذي الحجة سنة 983هـ/1576م، ثم دانت مراكش العاصمة له من بعد، حيث تلقب بالمعتصم بالله السعدي.
التحالف مع العدو
لم يُعلن المتوكل الاستسلام الكامل، وطبقا لبعض المصادر التاريخية فإنه قد خاض ضد عمّيه 24 معركة خلال سنتين بعد خلعه انهزم فيها جميعا[11]. وفي النهاية أدرك أنه لن يجد الناصر ولا المعين لاستعادة عرشه السليب، ولأنه طالما تعاون ودخل في علاقات دبلوماسية وتجارية ممتازة مع القوى النصرانية الإسبانية والبرتغالية التي تحتل بلدان وموانئ السواحل المغربية في الشمال فقد قرّر اللجوء إليهم، وطلب العون منهم، وكانت مدينة “أصيلا” لا تزال تحت حكم صهره ومؤيده القائد عبد الكريم بن تودة، وقد أدرك المتوكل أن عون البرتغاليين له سيكون بمقابل كبير.
وبالفعل انتقل محمد المتوكل السعدي لاجئا إلى مدينة طنجة التي كانت خاضعة للاحتلال البرتغالي من قبل تلك الأحداث بنصف قرن تقريبا، وطلب العون منهم، وكان يمكن أن يُفسَّر الأمر على اعتبار أنه من الأساليب السياسية التي يسعى كل طرف فيها إلى حلفاء يدعمون موقفه ويؤيدون وجهته، لكن المتوكل وقع بالفعل في فخ الخيانة حين شرط عليه البرتغاليون التنازل عن مدن الساحل المغربي كلها بعد استعادته لعرشه.
وفي ذلك يقول مؤرخ “تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية” إن البرتغاليين “قالوا لمولاي محمد نحن خارجون وأنت معنا، فإن ظفرنا بالبلاد فلا قسم لنا معك فيها إلا السواحل، وما دونها فهو لك، فأنعم لهم بذلك، وتعاهدوا عليه، فعند ذلك حلفوا لهم في صلبانهم وحلف لهم هو على ما ذكر، وأخذوا في إقامة العمارة (الأسطول) والجيش ودفع المال وما يحتاجون إليه”.
ولم تتحرك القوات البرتغالية بقيادة دون سباستيان إلا بعد احتلال مدينة “أصيلا”، بعدما سلّمها المتوكل لهم على طبق من ذهب، وبسبب ذلك ظهر المتوكل على الله أمام العلماء والعامة خائنا لوطنه ودينه، وأرسل إليه علماء المغرب رسالة شديدة اللهجة والحدّة يتهمونه فيها بالخيانة والكفر والتحالف مع الأعداء، جاء فيها: “اتّفقتَ معهم (البرتغاليين) على دخول أصيلا، وأعطيتهم بلاد الإسلام، فيا لله ويا لرسوله هذه المصيبة التي أحدثتَها، وعلى المسلمين فتقتها، ولكن الله تعالى لك ولهم بالمرصاد، ثم لم تتمالك أن ألقيتَ نفسك إليهم، ورضيت بجوارهم، وموالاتهم… وأما قولك في النصارى (البرتغاليين) أنك رجعتَ إلى أهل العدوة واستنكفتَ أن تُسمّيهم بالنصارى ففيه المقت الذي لا يخفى.
لم يرعوِ المتوكل على الله بهذه الرسالة، وتمادى يحث البرتغاليين بالإسراع لمواجهة السلطان السعدي الجديد المعتصم بالله عبد الملك وقواته، وكان عبد الملك يتابع عن كثب تحركات ابن أخيه، فأخذ على الفور قراره بتأليب القبائل وتهيئة القوات العسكرية ضده.
معركة “الملوك الثلاثة”.. “وادي المخازن”
قاد الملك البرتغالي قوات جرارة تفاوتت المصادر التاريخية في ذكرها، ما بين مئة وخمسين ألف مقاتل وثمانين ألفا، وأرسى جميع قطع أسطوله بمدينة أصيلا التي اتُّخذت للانطلاق لغزو المغرب، وقد كان وصول القوات المهاجمة يوم الاثنين 12 يوليو/تموز 1578م/ جمادى الأولى 986هـ حيث عسكرت بضواحي مدينة أصيلا، بالإضافة إلى قوات المتوكل على الله التي كانت تُقدَّر بنحو خمسمئة فارس فقط.
بقيت قوات الحملة البرتغالية بضواحي مدينة أصيلا أسبوعين تقريبا، حيث كان المعتصم عبد الملك السعدي قد عسكرَ بقواته عند سوق الخميس على بُعد ستة أميال جنوب وادي القصر الكبير، وكاتب المعتصم سباستيان قائلا: “إني قد جئتُك من مراكش، ورحلت إليك ست عشرة مرحلة (من 600 إلى 700كم) وأنت لم تدنُ إليّ مرحلة واحدة”، والمرحلة مسافيا تقدر بـ 44 كيلومترا تقريبا، وكان السلطان عبد الملك يهدف من وراء ذلك الخطاب إلى إبعاد سباستيان وقواته عن قواعدها ومراكز تموينها ليسهل القضاء عليها، ولو بمقدار مرحلة واحدة.
وبالفعل تحرك سباستيان حين أدرك أن المعتصم وقواته لن تتقدَّم أكثر من ذلك، وأخيرا اقترب الجانبان في وادي المخازن بعد عبور البرتغاليين نهره، جنوب مدينة “القصر الكبير” أو “قصر كتامة”، التي تقع شمال المغرب، وذلك في 30 جمادى الآخرة 986 هـ/ 4 أغسطس/آب 1578م، وكان السلطان المعتصم عبد الملك قد اشتد به المرض ليلة المعركة، وفي صبيحتها أمر فِرقة من قواته بهدم قنطرة نهر وادي المخازن حتى لا يجد البرتغاليون طريقا للرجعة.
يقول السلاوي في كتابه “الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى” عن تلك الأجواء: “لما التقت الفئتان، وزحف الناس بعضهم إلى بعض، وحمي الوطيس، واسودّ الجوّ بنقع الجياد، ودخان المدافع، وقامت الحرب على ساق؛ تُوفي السلطان أبو مروان (عبد الملك) رحمه الله عند الصدمة الأولى، وكان مريضا يُقاد به في محفّة (نقّالة)، فكان من قضاء الله السابق ولُطفه السابغ أنه لم يطلع على وفاته أحد إلا حاجبه مولاه رضوان العلج، فإنه كتم موته وصار يختلف إلى الأجناد، ويقول السلطان يأمر فلانا أن يذهب إلى موضع كذا، وفلانا يلزم الراية، وفلانا يتقدم، وفلانا يتأخّر”.
على أن المولى أحمد المنصور أخا السلطان المتوفى، والي مدينة فاس الحاضر في تلك المعركة، لما وقف على وفاة أخيه المعتصم، تسلّم زمام قيادة المعركة مع رضوان الحاجب، وقد اشتد وطيسها، وأذن الله بانتصار قوات المسلمين على البرتغاليين وحليفهم الخائن السلطان المخلوع المتوكل على الله، بل قُتل دون سباستيان في قلب المعركة، وحاول المتوكل الهرب لكنه غرق في نهر وادي المخازن، وكان المعتصم قد جاء أجله في اليوم ذاته، فسُميت المعركة بـ “معركة الملوك الثلاثة” لهذا السبب.
“بواتييه” المغرب الأقصى!
عقب ذلك الانتصار، جمعَ الملكُ المنصور أحمد السعدي كبار قادة الجيش والشرفاء والوجهاء والأتراك الذين قدموا بفرقة عسكرية داعمة لحليفهم المعتصم عبد الملك، فأخبر الجميع بموت أخيه، وتوليه أمور البلاد، وبعد محاولة فاشلة من العثمانيين الأتراك لتولية ابن حليفهم إسماعيل بن عبد الملك، أصرّ المغاربة على مبايعة السلطان الجديد المنصور أحمد السعدي، لأن السلطان السابق عبد الملك المعتصم كان قد أوصى بالأمر لأخيه المولى أحمد منذ أن شعر بالمرض، قائلا له: “فاعلم أني لا أحبّ أحدا بعد نفسي محبتي لك، ورغبتي في انتقال هذا الأمر بعد إلا إليك لا لغيرك”.
انتصر المغاربة بعد هذه الملحمة البطولية، بعد مساعدة سخية من العثمانيين الذين جاؤوا بخمسة آلاف مقاتل تركي من الجزائر، وفي نهاية المعركة عُثر على جثة المتوكل طافية عند نهر وادي المخازن، فأُمر بسلخها وحشوها تبنا وإرسالها إلى مراكش وغيرها لتكون للناس عبرة جراء خيانته وتحالفه مع أعداء وطنه ودينه، فسُمّي من يومئذ بالسلطان “المسلوخ”.
وهكذا كانت معركة القصر الكبير التي شغلت الرأي العام العالمي حينذاك لفترة طويلة، لما لها من نتائج، فهي بالنسبة للمسلمين في المغرب وبقية العالم الإسلامي كانت بمنزلة معركة “بواتييه” أو “بلاط الشهداء” في أوروبا، وقد أسفرت المعركة عن العديد من النتائج التي تركت بصماتها واضحة جلية على خريطة العالم المعاصر في ذلك الوقت، فقد استمرت المعركة ست ساعات هُزمت فيها البرتغال وحلفاؤها جميعا، لم ينجُ من الأسر والقتل فيها إلا مئة رجل، وأنهت هذه المعركة أسطورة دولة البرتغال القوية آنذاك، وأبرزت إفلاس الحملات الصليبية على العالم الإسلامي، والتي كان البرتغاليون يتقربون بها إلى البابوية في بلاد المغرب أو غيرها من بلاد العالم الإسلامي.